المركزية الأفريقية: أو أزمة المجتمع الأمريكي التي تُرحل شرقًا
بعد أن ظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأفارقة القادمين من الولايات المتحدة من داخل المتحف المصري, تصاعدت ردود الأفعال نظرًا لانتماء هذه المجموعة لحركة “الأفروسنترزم” أو “المركزية الأفريقية”, هذه الحركة التي تدعي من بين أشياء كثيرة أن الحضارة المصرية القديمة انتمت بكاملها للعرق الأسود الأفريقي, وأن المصريين المقيمين حاليًا في مصر هم غزاة مستوطنون من شعوب أخرى عربية وأوروبية.
وقد انتشر الحديث عن هذه الحركة التي تحمل تصورات ذات طابع عرقي وهوياتي تجاه الحضارة المصرية القديمة كثيرًا في الآونة الأخيرة, بالأخص منذ العام الماضي, حين قامت منصة نتفلكس لإنتاج الأفلام بإنتاج فيلم عن كليوباترا الملكة المصرية في العصر البطلمي, وانتمت بطلة الفيلم إلى العرق الأسود, على عكس حقيقة أصل كليوباترا التي عُرف عنها أصلها اليوناني. منذ ذلك الحين انتشر الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي حول حركة المركزية الأفريقية, التي نجحت بالفعل في إقناع عدد كبير من المواطنين في أمريكا أن الحضارة المصرية القديمة تنتمي بالكامل إلى العرق الأسود وأن المصريين الحاليون ليسوا سكان مصر الأصليين.
مستهدفات وسياقات المركزية الأفريقية
تنتشر حركة المركزية الأفريقية وأفكارها بالأخص بين الأمريكيين الأفارقة, وهي حركة تسعى لإثبات ثراء ومساهمة العنصر الأفريقي في الحضارة الإنسانية في مجملها, اعتقادًا منهم أنهم بذلك يواجهون الرؤى المركزية الأوروبية التي تسعى للتأكيد على دور العرق الأبيض الأساسي في التاريخ , باعتبار أن العرق الأبيض هو صانع الحضارة الأساسي.
وفي سياق ذلك, تعمل الحركة بالأساس على إعادة قراءة التاريخ الإنساني من هذا المنظور, فتفترض وتزعم الأصل الأفريقي لعديد من المكونات الحضارية المختلفة, وبالطبع, ولأن الحضارة المصرية القديمة هي الحضارة الأقدم وصاحبة الدور الأبرز في التأسيس الحضاري للحضارة الإنسانية برمتها, يسعى المركزيون الأفريقيون بضراوة لإثبات الأصل العرقي الأفريقي للحضارة المصرية القديمة, ومعها مجمل المنتج الحضاري لشمال أفريقيا, بل ويذهب الأمر أبعد من ذلك, حيث تظهر الأصوات التي تدعي الأصل الأفريقي الأسود للحضارة الأوروبية ذاتها, عبر القول بأن مؤسسي اليونان القديمة كانوا من الأفارقة كذلك.
تسعى الحركة كما تعلن بوضوح أنها تريد إعادة كتابة التاريخ, التي تدعي أنه كتب من منظور مركزي أوروبي يغفل عمدًا دور الأفارقة في الحضارة, ولكن هل تؤسس الحركة مسعاها ذلك عبر حقائق تاريخية؟
في كتاب أستاذ التاريخ الأفريقي كلارنس ووكر بعنوان “لا يمكننا العودة إلى الوطن مرة أخرى: حجة حول المركزية الأفريقية”، ينتقد المؤرخ ووكر المركزية الأفريقية، التي أصبحت حركة شعبية في المدارس والجامعات، وكذلك المجتمعات السوداء على مدى العقود الأربعة الماضية.
يقول وولكر في الكتاب أن: “العلماء الذين يسمون أنفسهم مركزيون أفريقيون لم يكتبوا التاريخ بالمعنى الدقيق للكلمة؛ ما أنتجوه هي أساطير علاجية مصممة لاستعادة احترام الذات لدى الأمريكيين السود من خلال خلق ماض لم يحدث أبدًا”.
يشير ووكر، المتخصص في دراسة التاريخ الأسود وعلم اجتماع العلاقات العرقية الأمريكية والثقافة الشعبية الأمريكية، إلى أن المركزية الأفريقية صامتة بشأن سياق العبودية وتجارة الرقيق. ويقول إن معظم السود الذين تم نقلهم إلى الأمريكتين كانوا عبيدًا في إفريقيا أو احتلوا موقعا تابعًا في المجتمع الأفريقي. حيث لم تمنع القبلية الأفارقة من بيع أفراد قبائلهم من أجل تلبية الطلب على العبيد في الأمريكتين”.
يقول: “في سياق السياسة السياسية والثقافية السوداء المعاصرة، تشكل المركزية الأفريقية شكلاً من أشكال التفكير الجماعي الشمولي”.
حركة عرقية أم أزمة اجتماعية
يبدو إذًا أن المركزية الأفريقية هي اتجاه له أبعاد سياسية ينتشر بالأخص في المجتمع الأمريكي بين أوساط السود الأمريكيين, وليس الانتشار في هذه الأوساط من قبيل الصدفة, فقد عانى السود الأمريكان من تاريخ من العبودية منذ تأسيس الولايات المتحدة حتى حصولهم على الحرية عام 1865, ومنذ ذلك الحين لا تزال المجموعات السوداء في الولايات المتحدة تعاني من التهميش الاقتصادي والاجتماعي. فهذه الحركة التي تحاول إعادة كتابة التاريخ لتحقيق قدر من الإنصاف المعنوي للسود في الولايات المتحدة تأتي في سياق الاحتقان المستمر والأزمة الدائمة في داخل المجتمع الأمريكي, هذا المجتمع الذي لا يزال حتى اليوم يعاني من التمييز على أساس عرقي, ولا يزال يحتفظ فيه العرق الأبيض بالتمايز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, على الرغم من كل المحاولات التي تسعى للمساواة بين جميع المواطنين.
لم يتغير الوضع كثيرًا في الولايات المتحدة بهذا الشأن حتى اليوم, فلا يزال الأمريكيون من أصول أوروبية هم المجموعة الأكثر حظًا في السياق الأمريكي بصورة شاملة, من حيث عدد الأثرياء منهم, وعدد متقلدي المناصب الرسمية, ومن حيث مؤشرات الثروة والحصول على التعليم والفرص الاجتماعية بمختلف صورها.
على مستوى التعليم مثلًا, تظهر الدراسات أنه لعقود, تخلف الطلاب السود في الولايات المتحدة عن أقرانهم البيض في التحصيل الدراسي. في عام 2019، كان معدل التخرج من المدارس الثانوية للطلاب البيض 87%، وفقًا للمركز الوطني لإحصاءات التعليم. بالنسبة للطلاب السود، كان المعدل 73%. تظهر درجات الاختبار فجوة عرقية مماثلة.
من المؤكد أن العديد من العوامل تساهم في فجوة الإنجاز التعليمي بين العرقين، بما في ذلك بيئات التنشئة في المنازل والأحياء السكنية وعوامل الدراسة التي لا علاقة لها بأداء المعلمين. لكن أصبح من المستحيل تجاهل ديناميكية محددة: اختلافات ملحوظة في الطريقة التي يعامل بها المعلمون ومديرو المدارس الطلاب السود. تظهر الأبحاث أنه بالمقارنة مع الطلاب البيض، من المرجح أن يتم تعليق دراسة الطلاب السود أو طردهم، وأن فرصهم أقل في أن يتم قبولهم في برامج الموهوبين ويخضعون لتوقعات أقل من معلميهم.
ويشير هذا المؤشر التعليمي العارض في الولايات المتحدة, أن الطلاب السود في عموم البلد الكبير يعانون من سياقات اجتماعية لا تدعم التفوق الدراسي, مما يعني أن السود بصورة عامة لديهم سياقات معيشية أكثر ترديًا من نظرائهم البيض, في تمركزهم بمناطق سكنية أكثر فقرًا وأقل رفاهية من الأحياء التي يغلب عليها العرق الأبيض.
والحديث عن انعدام المساواة الاجتماعية على أساس عرقي في الولايات المتحدة يطول, ويوجد من الأرقام والبيانات الاقتصادية ما يؤكده, وهو ليس موضع إنكار في السياق السياسي الداخلي بالولايات المتحدة, حيث يعترف به الخطاب السياسي الرسمي في الولايات المتحدة عبر قطبي الحياة السياسية, أي كل من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري.
إما قوة كبرى أو إنهاء عدم المساواة
الحقيقة أن مثل هذا التصدي لمشكلة انعدام العدالة بين الأعراق سيتطلب تحولًا جذريًا في النظام الاقتصادي والاجتماعي للولايات المتحدة, بحيث تتغير أولويات الإنفاق العام في الولايات المتحدة من بنود لأخرى, فعوضًا عن الإنفاق المهول على القدرات العسكرية, ودعم قطاعات اقتصادية كبرى تعبر عن جماعات مصالح متنوعة في الداخل, والإنفاق على ميزانيات البحث العلمي لأغراض عسكرية وتجارية, سيكون على الحكومات الأمريكية توجيه إنفاقها نحو الضمان والدعم الاجتماعي, وتوفير نظام صحي شامل تدعمه الدولة, ودعم تعليم يضمن تكافؤ الفرص وغيرها من أوجه الإنفاق التي تتطلب تحولًا في هيكل الاقتصاد الأمريكي الذي بنى بالأساس لغرض خدمة “القوة الكبرى” التي عليها أن تضمن تفوقها التكنولوجي والعسكري على بقية دول العالم لتظل في الصدارة. فاختيار تحقيق المساواة بين كل مكونات الشعب الأمريكي, يعني التضحية بالتفوق الهائل في القوة الذي تمتلكه الولايات المتحدة على دول العالم الكبرى الأخرى, وكذلك إعادة ترتيب الهرم الاجتماعي, بحيث تخسر بعض الفئات الثرية بعض المميزات التي تحصل عليها من الدولة, وأبرزها انخفاض الضرائب مقارنة بالدول الأخرى في العالم المتقدم وأبرزها الدول الأوروبية.
وقد عبر عن هذه الثنائية المتعارضة بين القضاء على انعدام المساواة في الولايات المتحدة وبين فاتورة أن تظل البلاد كقوى عظمى السياسي الأمريكي الاشتراكي بيرني ساندرز, ومعه الاقتصادي الأمريكي اليساري ريتشارد وولف, وهو ما عرضه هذا الأخير في كتابه المعنون “المأزق الأمريكي والخيارات الجيوسياسية”.
فاتورة نفقات بقاء القوى العظمى على حالها هي ما تحول إذًا ضد حل قضية عدم المساواة الأمريكية التي تأخذ طابعًا عرقيًا في البلد الرأسمالي الأول في العالم.
وبالفعل, حسمت النخب الأمريكية الحاكمة موقفها من هذه المسألة المتأزمة منذ بداية الألفينات, حسب الكاتب والمؤرخ الأمريكي رونالد فالنسي, وتجسد أمامنا موقفها من دعم لحركة المركزية الأفريقية, الحل في معضلة عدم المساواة لا يكمن في القضاء الفعلي عليها, بل التعويض المعنوي عنها لدى السود بدعم وتأييد الحرب الثقافية والحضارية على حضارات شمال أفريقيا وأوروبا.
المركزية الأفريقية بديل التحرر الأفريقي
وهذا ما يفسر توجه منصات إعلامية وفنية وثقافية أمريكية وغربية على العمل وفقًا لأجندة المركزية الأفريقية ورؤيتها للتاريخ, حيث الشخصيات التاريخية المعروف أصلها العرقي غير الأفريقي تطل علينا بسمات أفريقية. والحضارات القديمة كلها تصبح سوداء الأصل.
والأمر المؤسف, أنه بعد انتهاء تأثير الحركة السابقة على المركزية الأفريقية في صفوف السود الأمريكيين, وهي حركة التحرر الأفريقي والوحدة الأفريقية التي اتسمت بالطابع اليساري الطامح في تغيير النظام الاقتصادي الاجتماعي, حل محلها حركة المركزية الأفريقية ثقافوية الطابع. وقد استجاب النشطاء السود لهذا التحول.
وفي نظر رونالد فالنسي, فإن هناك مخططا أمريكيا على مستوى النخبة الحاكمة قد تمت صياغته لاستبدال حركة التحرر والوحدة الأفريقية بحركة المركزية الأفريقية, وذلك ببساطة لأن حركة الوحدة الأفريقية كانت حركة مناهضة للرأسمالية والدور الإمبريالي الأمريكي في استعمار أفريقيا, أما حركة المركزية الأفريقية فهي تركز على صراعات ثقافية وتاريخية مع شعوب أخرى بشكل يحرف الصراع عن أساسه الفعلي. وهذا المخطط قد نجح فعليًا حسب فالنسي, وأصبحت معارك السود الأمريكيين الآن مع المصريين المعاصرين الذين استولوا على حضارتهم كما يتوهمون, وكذا مع المغاربة والتونسيين والجزائريين الذين استولوا على الأرض الأفريقية التي تنمتي للعرق الأفريقي, أو هكذا يتصورون. وبهذا ينتقل تركيز الأفارقة على معارك أخرى. وميكانزمات تحقيق النصر في هذا الصراع تتحقق عبر إحراز نقاط تتمثل في المستوى الرمزي فقط, أي بمجرد تغيير الحقائق التاريخية ونسب شخصيات تاريخية ومكونات حضارية إلى العنصر الأفريقي, حيث تنتصر الحركة حين تُصوَر كليوباترا كامرأة سوداء, أو حتى في أن يظهر الفايكنجز الأوائل ببشرة سوداء, أو شخصيات شكسبير التاريخية باللون الداكن.
مشكلة غربية أخرى تنتقل إلى الشرق
في الأمس, وقياسًا على الراهن, تحول اضطهاد اليهود في القارة الأوروبية إلى مشكلة عويصة, وصلت ذروتها بالحملة النازية ضدهم منذ عام1936 حتى عام 1945, وكانت الحركة الصهوينية بالفعل حركة أنشئت بمخطط بريطاني لترحيل المشكلة اليهودية إلى الشرق الأوسط, وهو ما انتهى بقيام دولة إسرائيل.
يشير مراقبون إلى إمكانية تكرار الأمر مع الأمريكيين الأفارقة, فالمشكلة الاقتصادية الاجتماعية المتعلقة بهم يتطلب حلها تحول في النظام الاقتصادي تحولًا شاملًا, وهو ثمن باهظ ينهي التفوق الأمريكي في القطاع العسكري والتكنولوجي, فمن الممكن أن تنتهي الدعوة المركزية الأفريقية إلى أمر مماثل, ويطالب السود بالعودة إلى كيميت المتخيلة, هو أمر صعب التحقق لكنه ليس مستحيلًا.
على أي حال, سواء سعت مجموعات لتحقيق هذا السيناريو أو لم تسع, فقد نجحت النخب الأمريكية الحاكمة في إطلاق موجة من الصراعات القائمة على الهوية حول العالم مرة أخرى, وأصبح المصريون وشعوب الشرق مكرهين على الدخول في صراع على تاريخهم وهويتهم, وهو صراع عبثي ينطلق من أرضية لا تاريخية. فمطلقو هذا النوع من الصراعات لديهم أغراض تؤكد همينتهم, حيث تحرف هذه الصراعات الهوياتية الوعي الوطني التحرري لدى شعوب العالم, وتدفع به نحو النزعات الشوفينية المتعصبة, فتُنسىَ قضايا التحرر والعدل الاجتماعي والتكافؤ العالمي لصالح الصراع على الهوية, وتستدعى الهوية الدينية أيضًا في خضم هذا الصراع, وتعود قضايا لم تحل بعد على الساحة مرة أخرى. فصراعات الهوية تستدعي التعصب الديني والقومي والعرقي في نهاية الأمر, وتطغى صراعات وهمية على الصراع الواقعي الأساسي, وهو الصراع الاجتماعي الذي يأخذ طابعًا وطنيًا.
وعلاوة على ذلك علينا أن نعترف مشكلة الهوية لا تزال عالقة في مصر والشرق الأوسط, فالتحول الحضاري الضروري من الدولة الإمبراطورية إلى الدولة الحديثة لا يزال غير مكتمل في بلادنا, ولا يزال المواطن الشرقي يقف أمام سؤال الهوية, هل هو مسلم أم مصري أم عربي أم كردي أم نوبي, وإذا كان هذا السؤال لم يجب عنه إجابة قاطعة واضحة تفترض سيادة الجنسية الوطنية على أي مكون هوياتي آخر, فهذا يعني أن استثمار النخب الأمريكية الحاكمة في مثل هذا الصراع هو استثمار ناجح في سياق المصالح الإمبريالية للقوة الأمريكية العظمى.
التصدي لمخطط التزييف التاريخي يتطلب وعيًا قوميًا ووطنيًا يعالج أولًا مشكلة الهوية في مصر والمنطقة, والتغلب على نزعات التطرف الديني التي تحاول تهميش ما هو وطني لصالح ما هو ديني, قبل الشروع في مواجهة دعوات المركزية الأفريقية وغيرها من الدعوات الهوياتية التبسيطية التي تختزل الصراعات اليومية في قضية الهوية. ومن ثم تتجه الدولة للعمل على مكافحة الإدعاءات التي يطلقها أنصار المركزية الأفريقية بوعي يدرك خطورة هذه الدعوات بما تحمله من مستهدفات تهدد بقاء الأمة المصرية على كلٍ من المستوى المادي والمعنوي للصراع.

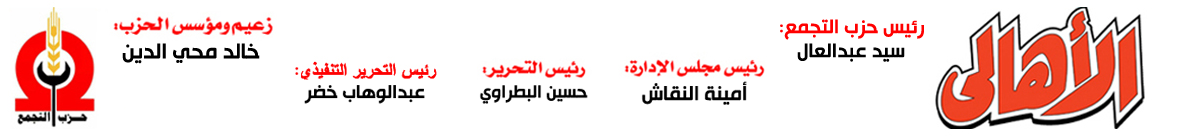

التعليقات متوقفه